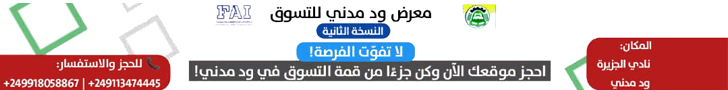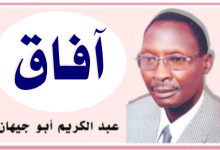أصل القضية/ محمد أحمد أبوبكر…السودان: بين “إدارة الأزمة” و”الإدارة بالأزمة”
> الثروة التي لا تُحكم تُهدر، والأزمة التي لا تُدار تُعاد.
السودان بلدٌ مغمورٌ بالموارد ومحاصرٌ بالاختناقات. وبين وفرةٍ وعجزٍ، يبرز السؤال الحاد: هل نحن أمام فشلٍ في إدارة الأزمة، أم أننا نُساق بمنهج الإدارة بالأزمة؟ هذا المقال يشرح الفارق بين الطريقتين تشخيصًا ومنهجًا، ثم يرسم طريق الخلاص وفق رؤية الجسر والمورد.
أولًا: ما هي “الإدارة بالأزمة”؟
التعريف: نمط حكم يوظّف الأزمات (أو يفتعلها/يُبقيها دون حل) كأداة للسيطرة وإعادة توزيع القوة والموارد. ليست مصادفةً عابرة، بل هندسةٌ للأزمة لإدامة وضعٍ يخدم قلةً ويستنزف الدولة والمجتمع.
كيف تعمل؟ (الميكانيزمات):
١. تصنيع الندرة: تعطيل متعمّد لسلاسل التوريد/الخدمات لتبرير قرارات فوقية. مثال: أزمة الخبز ٢٠١٨م حيث أُدير النقص كأداة سياسية بدل أن يُحل جذريًا.
٢. تدوير الفشل: حلّ ترقيعي يولّد أزمةً جديدة تُستغل سياسيًا. مثال: أزمة الوقود ٢٠٢١م حيث تحولت الحلول الجزئية (الصفوف/التوزيع بالكوتة) إلى وقودٍ لأزمات متكررة.
٣. تشتيت الانتباه: تضخيم عدوٍ داخلي/خارجي لصرف النظر عن أصل المشكلة.
٤. اقتصاد الظل: ترك مساحات رمادية تنتفع منها شبكات نفوذ خارج الموازنة.
٥. تعطيل المؤسسات: إبقاء اللجان والكيانات في حالة عدم يقين، وخلق تداخل في الصلاحيات. مثال: أزمة اللجان الكثيرة بعد ٢٠٢٣م حيث تداخلت لجان الطوارئ والخدمات دون وضوح أدوار.
٦. إستراتيجية الصدمة المستمرة: الانتقال السريع من أزمة لأخرى لإرهاق الرأي العام.
■ المحصّلة:
●دولة توازنات لا دولة مؤسسات.
●تفكك العقد الاجتماعي، وهجرة العقول، وتآكل الثقة.
●تكاليف مرتفعة جدًا على الموارد، بلا إنجاز قابل للقياس.
■ مؤشرات التشخيص (Checklist سريع):
● قرارات مفصلية بلا بيانات منشورة.
● تعدد مراكز قرار واختلاط الصلاحيات.
● تضارب الرسائل الإعلامية وقت الأزمات.
● غلبة الجبايات غير المباشرة والرسوم غير الموحّدة.
● تمويل طوارئ بلا شفافية أو مراجعة لاحقة.
● حلول قصيرة الأجل تُنتج مشكلات أكبر.
● تمديد “المؤقت” إلى أجل غير مسمى.
● غياب جداول زمنية ومسؤوليات محددة بالاسم.
● ارتفاع حادّ في “تكلفة الامتثال” للمواطن/المستثمر.
● توسّع اقتصاد نقدي/موازٍ خارج الرقابة.
ثانيًا: ما هي “إدارة الأزمة”؟
التعريف: منظومة احترافية لإدارة المخاطر تمرّ بأربع حلقات متصلة: الوقاية/الجاهزية → الاستجابة → التعافي → التعلّم والتحسين. هدفها تقليل الخسائر وتسريع العودة لوضع أفضل مما كان.
■ مرتكزات منهجية:
●وحدة القيادة: هيكل قيادي واضح (Incident Command) بصلاحيات محددة.
●القرار المبني على البيانات: مصفوفات مخاطر، سيناريوهات، نماذج توقع.
●شفافية الاتصال: خط رسائل موحّد، تحديثات دورية، قنوات بلاغات للمواطنين.
RACI لتحديد الأدوار: من المسؤول؟ من يعتمد؟ من يُستشار؟ من يُبلّغ؟
تمويل مرن: صندوق طوارئ بقواعد صرف مسبقة وإفصاح لاحق.
■ مراجعة بعد الحدث (AAR): ماذا نجح؟ ماذا فشل؟ كيف نصحّح؟
■ أدوات عملية:
مركز وطني للمخاطر والإنذار المبكر.
●لوحة قيادة (Dashboard) عامة تُظهر المؤشرات الحيوية.
●خريطة أصحاب المصلحة وخطة تواصل لكل فئة.
●عقود جاهزية لوجستية (نقل، تخزين، مشتريات) مسبقة التفاوض.
●تمارين محاكاة وسيناريوهات فصلية.
■ مؤشرات النجاح: انخفاض زمن الاستجابة، تقليص الخسائر، تسارع التعافي، توحيد الخطاب، ونشر التقارير الختامية للمساءلة والتعلّم.
ثالثًا: لماذا يتعثر السودان بين النمطين؟
●فجوة الإرادة والحوكمة: تغليب الولاء على الكفاءة، وضعف استقلالية مؤسسات الرقابة.
●اقتصاد ريعيّ/موازٍ: يلتهم العائدات ويضعف قاعدة الضرائب الرسمية.
●مركزية مفرطة: خنق الحكم المحلي ومنعه من حلّ مشكلاته في الميدان.
●عطب البيانات: شحّ قواعد بيانات محدثة عن الموارد، الإنتاج، التجارة، الخدمات.
●تسييس الخدمات: إدخال الاعتبارات الفئوية في توزيع السلع الأساسية.
●تداخل المسارات الأمنية/المدنية: غياب خط فصل مؤسسي واضح وقت الأزمات.
رابعًا: طريق الخلاص وفق رؤية الجسر والمورد
أن نكون جسرًا يصل الداخل بالداخل أولًا ثم بالعالم، وأن نحول المورد من غنيمة تُقسّم إلى قيمة إنتاجية تُضاعف.
أصل القضية أن نختار. فالإدارة بالأزمة تُبقينا أسرى دوّامةٍ لا قاع لها. أمّا إدارة الأزمة فتعيد النظام إلى الفوضى، لكن إدارة التنمية – وفق رؤية الجسر والمورد – هي القفزة النوعية: حين تتحوّل الموارد إلى قيمةٍ مُنتجة، والمؤسسات إلى جسرٍ يعبر به الجميع، لا منصةٍ يحتكرها أحد.
الخلاص ليس شعارًا؛ الخلاص هندسة إرادةٍ ومعرفةٍ وموارد—مثلثٌ إذا اكتمل، اكتملت الدولة.
باحث بمركز الخبراء للدراسات