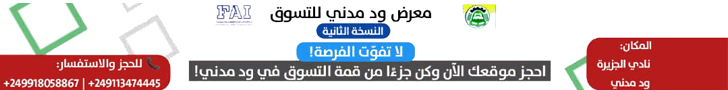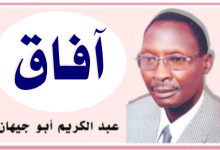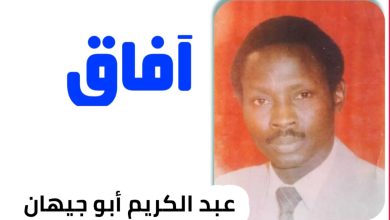أصل القضية/ محمد أحمد أبوبكر.. السودان… بين التحول الرقمي والتحلل المؤسسي
| من سلسلة الجسر والمورد
> “المابتشوفه في بيت أبوك بيخلعك.”
عبارة من عمق الوجدان السوداني تصلح مدخلًا لتشريح الحالة الراهنة: حالة دولة تحاول بناء بيتها من الداخل بينما لا تزال الأعمدة تتهاوى من الخارج.
في هذا المناخ المضطرب، صدر قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بإنشاء ثلاث هيئات وطنية تحت إشراف وزارة التحول الرقمي والاتصالات: هيئة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السودانية، وهيئة الأمن السيبراني.
قرارات تبدو للوهلة الأولى علامة وعي بالمستقبل، لكنها تفتح بابًا واسعًا على أسئلة أكثر جوهرية:
هل نستطيع التحول رقمياً في بلد لم يتحول بعد من الحرب إلى السلم؟
وهل الرقمنة في غياب الإعمار، إلا محاولة للركض نحو الأمام بينما الجغرافيا لا تزال واقفة على أطلالها؟
أولاً: التحول الرقمي في غير أوانه
إنشاء هيئات رقمية في لحظة تفكك مؤسسي يشبه وضع سقف لبيت لم يُصبّ له أساس بعد.
التحول الرقمي في مفهومه ليس إدخال التكنولوجيا، بل إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة.
فحين تكون الإدارات العامة معطوبة، والبيئة القانونية هشة، والبنية التحتية مدمرة، فإن الرقمنة تتحول إلى ديكور إداري أكثر منها رافعة سيادية.
الخرطوم نفسها — العاصمة السياسية والرمزية — لم تبرأ بعد من آثار الحرب، لم تُرفع أنقاضها بالكامل، ولم تستعد مؤسساتها المدنية فاعليتها.
في مثل هذا المشهد، ما الذي يمكن أن تعنيه هيئة للذكاء الاصطناعي؟
وكيف يمكن الحديث عن أمن سيبراني بينما الأمن المادي للدولة ما زال قيد التفاوض في الميدان؟
ثانياً: بين من يخطط للسودان ومن يخطط للحكومة
ثمة فارق جوهري بين من يخطط للسودان ومن يخطط للحكومة.
فالأول ينظر إلى الوطن كمشروع حضاري طويل الأمد، بينما الثاني يتعامل مع الدولة كإدارة مؤقتة لتجميل صورتها أو كسب شرعية آنية.
الهيئات الجديدة لن تكون ذات جدوى ما لم تكن جزءًا من مشروع وطني شامل للتحول الرقمي، لا مبادرة حكومية ذات عمر سياسي قصير.
ومن هنا ينبع السؤال المركزي في فلسفة “الجسر والمورد”:
> ما الذي ستفعله الرقمنة في السودان، والحرب وآثارها ما زالت ماثلة في العقول والخرائط؟
هل ستخدم سيادة السودان الرقمية باعتبارها واجبًا وطنيًا، أم ستكون مجرد واجب إداري لتحسين صورة حكومة مؤقتة؟
ثالثاً: من “السطحيون” إلى عمق التجربة السودانية
يقدم الكاتب نيكولاس كار في كتابه «السطحيون: ما يفعله الإنترنت بأدمغتنا» تحذيرًا عميقًا من أن الإفراط في الاعتماد على التقنية لا يوسع الوعي، بل يُسطّحه.
فالإنترنت – كما يرى – لا يضيف إلى تفكيرنا عمقًا، بل يستبدل التأمل بالتمرير، والفهم بالوصول السريع.
إذا أسقطنا هذه الفكرة على التجربة السودانية، فسنجد أن الخطر لا يكمن في الرقمنة ذاتها، بل في الرقمنة بلا فكر.
فما لم تكن التقنية أداة لتحرير الوعي المؤسسي، فإنها ستتحول إلى قيد جديد.
هنا، يصبح التحول الرقمي في السودان عرضة لأن يعيد إنتاج ما حذر منه كار:
سطحية رقمية فوق هشاشة سياسية.
التحول الرقمي الحقيقي يجب أن يكون إحياءً للذاكرة الوطنية عبر التوثيق، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على قاعدة الشفافية والمساءلة.
لكن إذا تم في بيئة منقسمة، فستتحول الرقمنة إلى أداة انقسام جديدة تُكرّس المركزية الرقمية بدلًا من توحيد الدولة عبر المعرفة.
رابعاً: الرقمنة بين الوعد والعبء
الرقمنة في دول ما بعد النزاعات عادةً ما تكون سيفًا ذا حدين:
فهي من جهة تمثل فرصة لإعادة تنظيم الدولة وتبسيط الخدمات، ومن جهة أخرى قد تفتح الباب لاختراق سيادتها المعلوماتية من الخارج.
والسودان اليوم يقف أمام هذا المفترق بالضبط:
هل ستكون الرقمنة جسرًا نحو بناء الدولة الحديثة أم مورداً جديدًا للاختراق والسيطرة؟
إن التحول الرقمي الذي لا يُدار بعقل استراتيجي سيادي يمكن أن يُحوّل بيانات المواطنين إلى سلعة، ويجعل الدولة رهينة لمزودي التكنولوجيا الأجانب.
ولذلك فإن بناء هيئة الأمن السيبراني يجب ألا يكون شعارًا تقنيًا، بل إستراتيجية وطنية للدفاع السيادي عن المجال الرقمي السوداني.
خامساً: من فوضى الفعل إلى وعي الفعل
لقد آن للسودان أن ينتقل من مرحلة “نفعل لأن الآخرين فعلوا” إلى مرحلة “نفعل لأننا نعرف ماذا نفعل”.
فحوجتنا ليست أن نفعل، بل أن نعرف ماذا نفعل، وكيف نفعل، وبأي وعي جمعي نفعل؛
نفعل بنون الجمع لا نون الأنا التي أورَدت السودان المهالك.
التحول الرقمي ليس لوحة تُعلّق في الوزارات، بل فلسفة إدارة تُعيد تعريف المسؤولية الوطنية على أسس الشفافية والمعرفة.
وحين نُدير التحول الرقمي بعقل الدولة لا بمزاج الحكومة، نكون قد وضعنا أول حجر في جسر السودان نحو المستقبل.
إذا كانت الحرب قد هدمت البنية المادية للسودان، فإن السطحية الرقمية قد تهدم بنيته الفكرية إن لم نحذر.
إن بناء الهيئات الثلاث يجب أن يُقرأ لا كفعل إداري، بل كاختبار لقدرتنا على الانتقال من ردّ الفعل إلى وعي الفعل، من الرقمنة الشكلية إلى التحول الوطني الشامل.
ما بين الأثير والكيان
وأنا أراجع هذا المقال قبل إرساله للنشر، كان الراديو بجانبي مضبوطًا على ٩٥ إف إم – إذاعة “هنا أم درمان”، أثير جمهورية السودان.
ينقطع البث ويعود، كأنه يلتقط أنفاس وطنٍ متعب يحاول أن يسمع نفسه.
ونظرتُ إلى شاشة تلفزيون جمهورية السودان، فإذا بها صورة باهتة تُصارع ضعف الإشارة وسوء البنية.
أليس من باب أولى أن نبدأ رقمنة الإعلام الرسمي قبل إنشاء هيئات عليا للذكاء الاصطناعي؟
أليست هذه المؤسسات – الإذاعة والتلفزيون – هي واجهة الدولة وصوتها وذاكرتها؟
إن رقمنتها ليست ترفًا، بل ضرورة سيادية لحماية هوية السودان في الفضاء الرقمي.
وهل في الموقف تناقض؟
قد يتبادر إلى ذهن متابعي أصل_القضية سؤال ؟؟!!
> “انت كنت تدعو للعملة الرقمية نيلوكوين، والآن تنتقد إنشاء الهيئات الثلاث… أليس هذا تناقضًا؟”
لكن دعونا نفكر: نيلوكوين كانت وسيلة، ليست مؤسسة. وسيلة رقمنة تخدم السيادة الوطنية والموارد، تقنية تُحرّر القرار السوداني وتفتح أفقًا جديدًا للاقتصاد الوطني.
أما الهيئات الثلاث فهي مؤسسات، أي كائنات قائمة بذاتها، تحتاج قاعدة مؤسساتية صلبة لتعمل بفاعلية. إن وُضعت في بيئة منهارة، تتحول الرقمنة فيها إلى شكل بلا مضمون، إلى واجهة بلا جسد.
الفرق واضح: نحن لا نرفض الرقمنة، بل نرفض الرقمنة بلا وعي.
نريد رقمنة الدولة، لا الحكومة؛ تقنية تعيد بناء الدولة لا مجرد تلميع واجهاتها.
وهكذا، الموقف واحد منذ البداية: من الرقمنة التي تُعزّز السيادة والوعي، لا من الرقمنة الشكلية التي تعكس هشاشة سياسية.
> نعم، دعوتُ إلى الرقمنة يومًا حين كانت السيادة هي الهدف، وأنتقدها اليوم حين أصبحت وسيلة تلميعٍ سياسي.
فالرقمنة ليست خيرًا مطلقًا ولا شرًا مطلقًا؛ هي مرآة تعكس وعي الدولة بنفسها.
إن لم نُصلح البنية التي تحمل الإشارة، فلن يسمعنا الأثير ولو ضبطنا الموجة على ٩٥ إف إم.
#أصل_القضية
التحول الرقمي ليس رفاهية تقنية، بل مشروع سيادي يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة، ومؤسسات إعلامية وأمنية متماسكة، وإرادة وطنية حقيقية.
أما أن نعلن قيام “هيئات رقمية” وسط ركام الإدارات، وانقطاع الأثير، وتلعثم الصورة، فذلك لا يعني تحولًا رقميًا بقدر ما يعكس تحولًا شكليًا في بلدٍ ما زال يبحث عن شكل دولته.