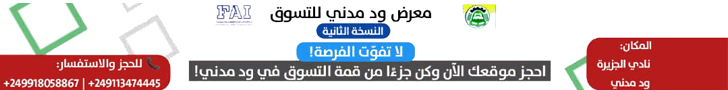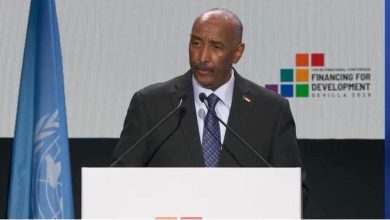أصل القضية/محمد أحمد أبوبكر.. حين يعيد السوداني إنتاج هزيمته بأدواته
في السودان، ثمّة ظاهرة تتجاوز حدود السياسة والانقسام، وتلامس الجذر العميق لأزمة الوعي الوطني. ظاهرة لا تُرى بالعين، لكنها تُحسّ في طريقة تفكير الناس، وفي خطابهم، وفي نظرتهم لأنفسهم وللآخرين. إنها ما يمكن تسميته—وفق استراتيجية «الجسر والمورد»—بـ :
> الاستلاب الداخلي المُعاد إنتاجه
> Cyclically Reproduced Internal Alienation
أو
> مركّب الانتقاص الذاتي السوداني
> The Sudanese Self-Devaluation Complex
وهما مصطلحان يصفان حالة نفسية – اجتماعية – سياسية، تتولد حين تمرّ الأمم بصدمات طويلة، فتنقلب بوصلتها نحو الخارج، وتتحول من نقد الذات لتحسينها… إلى هدم الذات وتحقيرها، ومن الرغبة في التعلم من الأمم الأخرى… إلى الاستلاب لها لدرجة فقدان الثقة في قيمة السوداني ذاته.
هذه الظاهرة ليست عابرة، وليست حالة نفسية فردية؛ إنها بنية ذهنية متوارثة، تعيد إنتاج نفسها في البيت، والمدرسة، والإعلام، والثقافة السياسية. وهنا تصبح الأزمة أخطر من السياسة، وأعمق من الصراع، لأنها تضرب أساس الدولة: الوعي.
١) مستوى الوعي: حين يتشوه الوعي الجمعي
تتراكم في العقل السوداني طبقات من الخطابات التي تقدّس الخارج وتزدري الداخل، ليس لأنها صحيحة، بل لأنها تنبع من جذور أربعة:
■ أولًا: تربية سياسية تقوم على احتكار التفكير
حيث ظلّ التفكير امتيازًا لمن “فوق”، بينما من “تحت” لا يُسمح له إلا بالاتباع.
فتنشأ أجيال تُلقّن أن رأيها خطأ قبل أن تتحدث، وأن صوابها يحتاج ختمًا من سلطة فوقية.
■ ثانيًا: ذاكرة استعمارية لم تلتئم
رسّخت أنّ التنمية والعقل والنهضة لا تأتي من السودان، وأن الحل دائمًا في الخارج.
ومع الزمن يتطبع العقل السوداني على فكرة أن الآخر أرقى، وأن السوداني—مهما حاول—ناقص.
■ ثالثًا: غياب رواية وطنية متماسكة
أمة بلا سردية موحدة ستبحث عن هويتها في مرآة الآخرين.
ولأن الآخر يملك هوية صلبة، بدا أجمل.
ولأن هويتنا متشظية، بدا السوداني أقلّ.
وهنا يستعيد الواقع معنى قول إيليا أبو ماضي:
«ووطنٌ ليس يعرف أهلهُ من كان فيهِ غريباً»
فنحن أصبحنا غرباء عن أنفسنا… قبل أن نغترب عن العالم.
٢) مستوى البنية: حين يتحول المجتمع إلى اصطفاف دائم
عندما تحتكر فئة «حق الكلام» و«حق التفكير» وتمنح نفسها أن تحدد:
من الوطني ومن الخائن،
من الثائر ومن الفلول،
من الإنسان ومن غير الموجود أصلًا…
فنحن أمام بنية تقسيم حقيقية، تُفرَض على الناس تحت شعارات الثورة أو النضال أو الوطنية.
وتنتج هذه البنية ثلاثة مظاهر خطيرة:
■ طبقية سياسية مقنّعة
تبدو كصراع أفكار، لكنها في الجوهر صراع امتيازات.
■ احتكار للعقل والرأي
كأنما التفكير وظيفة رسمية تُمنح لفئة دون غيرها.
■ إقصاء شامل للآخر المختلف
ليس لأن فكرته خاطئة، بل لأنه فقط… لا ينتمي للقطيع المطلوب.
وهكذا يصبح السودان ساحة اصطفاف لا تنتهي،
ويصبح الوعي الوطني رهينة خطاب الصراع، لا خطاب البناء.
٣) مستوى السلوك: السوداني ضد السوداني – نموذج التكسير الذاتي
السوداني ينتقد السوداني… إلى درجة السحق.
ليس نقدًا لإصلاح، بل نقدًا لإلغاء.
ليس مساءلة للسلوك، بل جلدًا للذات الوطنية.
ويعود هذا النمط إلى ثلاثة عوامل متجذرة:
■ العقل السوداني تشرّب عبر عقود أن نجاح السوداني مشبوه
فهو مرفوض حتى يثبت العكس.
ونجاحه نفسه يصبح تهمة.
■ الخوف من صعود فرد سوداني يكسر السقف التقليدي
فالمجتمع لا يسمح لقياداته الطبيعية أن تنمو.
كل من يعلو يُسحب إلى الأسفل.
■ ثقافة مقارنة غير عادلة مع الخارج
لا تقارن الإمكان بالإمكان، بل تقارن الذات المكسورة بمرآة الآخرين اللامعة.
وهكذا يصبح المجتمع—بحكم اللاوعي—أكبر عائق أمام تطور أبنائه.
قراءة الظاهرة ضمن استراتيجية الجسر والمورد
وفق هذه الاستراتيجية، التي ترى السودان كجسر لم يُستخدم ومورد لم يُستثمر،
تبرز هذه الظاهرة بوصفها:
> أخطر عوامل تعطيل الوعي الوطني
لأنها تُهدر القوة البشرية، وتُجهض إمكانات القيادة،
وتمنع المجتمع من الانتقال من مرحلة الحرب والصراع
إلى مرحلة بناء الدولة.
وهي أيضًا أحد الأسباب المركزية لفشل النخب السياسية:
فوعيٌ منقسمٌ على نفسه لا يستطيع إنتاج دولة،
ولا صناعة مسار،
ولا حماية مشروع وطني جامع.
#أصل_القضية،،،
ما يحدث في السودان ليس مجرد خلاف سياسي.
إنه:
ليس اختلاف رأي… بل إلغاء وجود.
ليس نقدًا… بل جلد ذاتٍ تحوّل إلى ثقافة.
ليس إصلاحًا… بل إعادة إنتاج الانقسام تحت أسماء جديدة.
إنها حالة عميقة من تشوّه الوعي الجمعي،
تستمر في تدوير الأزمة منذ عقود،
وتمنع عبور السودان من الخراب إلى الدولة.
وما هذه السطور إلا محاولة صغيرة نرمي بها سهمًا في ثغر معركة الوعي،
علّنا نعيد للسوداني قيمته،
وللذات الوطنية احترامها،
وللسودان مكانته التي يستحقها بين الأمم.
– باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية