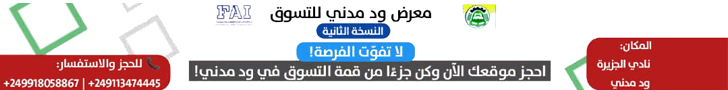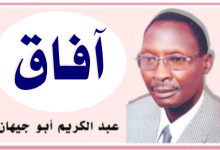أصل القضية/ محمد أحمد ابوبكر.. السردية السودانية… بين المصادر المفتوحة و الموجَّهة
|من سلسلة الجسر والمورد
في كل حقبة من تاريخ السودان، من الممالك النوبية إلى معركة الكرامة الراهنة، ظل سؤال السردية مُعلَّقًا فوق كل مؤسسة وكل قرار وكل خطاب: من يروي قصة الدولة؟ ومن يملك حق تشكيل وعي الناس بتاريخهم؟
هذا السؤال ليس ترفًا معرفيًا، بل هو بوابة لفهم كل ما جرى ويجري… من سقوط الدول إلى ارتباكات الانتقال، ومن صعود التحالفات إلى انهيار المواقف، ومن تشكل الوعي العام إلى انزلاقه في فوضى المعلومات.
وفي ظل عالم متخم بالمصادر المفتوحة، تقف في الجهة الأخرى مصادر موجَّهة تتقن صناعة التأثير، وتتحكم في مسارات الإدراك الجمعي… وهنا تتبدّى معركة أخطر من معركة الميدان:
> معركة امتلاك السردية.
بداية عزيزي القارئ ونحن على عهدنا في # أصل_القضية أن نبسط الأشياء لكي ننزلها منازلها، دعنا نجيب على سؤال ما هي المصادر الموجهة ؟؟ وما هي المصادر المفتوحة؟؟
١) المصادر الموجَّهة:
هي المصادر التي تصنع السردية أو توجيه الرأي العام وفق مصالح محددة، وغالبًا تتحكم بها جهات سياسية أو دولية.
مثالك: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية
هنا ليس الهدف الحقيقي حماية الأمن أو القانون، بل إعادة ترتيب النفوذ السياسي وخلق “فزاعة” لتبرير تحركات معينة على الساحة الداخلية والخارجية.
تتحكم هذه المصادر بما يراه الجمهور ويصدق أنه “التهديد الحقيقي”، بينما الواقع مختلف.
٢) المصادر المفتوحة:
هي المصادر التي تعكس الواقع الميداني أو المعلومات الخام، لكنها لا تُوجّهها أجندة سياسية بالضرورة.
مثالك: الدعوة للقوات المسلحة للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة
هذه معلومات حقيقية يمكن للجميع الوصول إليها من تقارير ميدانية، تقارير صحفية، أو مقاطع فيديو، لكنها لا تحمل توجيهًا سياسيًا مخططًا مسبقًا.
وظيفتها: تقديم الواقع كما هو، أو ما يمكن التحقق منه، لتساعد على التحليل واتخاذ القرار.
أولاً: سردية الدولة… حين تتقاطع الجغرافيا مع الوعي
السودان ليس مجرد مساحة على الخريطة؛ هو حكاية طويلة كتبتها الجغرافيا بمداد النيل والسهول والصحراء، ونسجتها الثقافات المتعددة، ثم جرفتها السياسة الحديثة في التيارات المتصارعة.
لكن الحكاية السودانية لم تُكتب مرة واحدة… بل قُطعت، وشُوّهت، وتحوّرت بحسب من جلس على الكرسي ومن سيطر على المنصة.
فكل عهد كان يُعيد ترتيب الماضي ليخدم مستقبله، ويعيد تشكيل الذاكرة لتخدم مشروعيته.
وهنا تبدأ الإشكالية:
> هل نملك سرديتنا فعلاً… أم نستعيرها من الآخرين؟
ثانيًا: المصادر المفتوحة… زخم بلا بوابة
في عصر ما بعد 2020، لم يعد المواطن ينتظر خطاب الدولة أو بيان المؤسسة.
المعلومة تنفجر أمامه عبر:
●تقارير مراكز بحث عالمية
●قواعد بيانات مفتوحة
●منصات تحليل استخبارية مدنية
●مقاطع فيديو من قلب الحدث
●صور أقمار اصطناعية تكشف ما كانت تخفيه الدول لعقود
> لكن هذه الوفرة المعرفية ليست بلا ثمن.
فالمصادر المفتوحة أجابت على سؤال “ماذا يحدث؟”، لكنها غالبًا عجزت عن الإجابة على “لماذا يحدث؟ ومن المستفيد؟”.
وتحوّلت إلى مرآة بلا إطار… كل يرى فيها ما يريد.
ثالثًا: المصادر الموجَّهة… هندسة الوعي
في الجهة الأخرى، تقف مصادر موجَّهة بعناية:
●غرف صناعة الرأي العام
●أجهزة دبلوماسية إعلامية
●سياسات خارجية تستخدم المعلومة كسلاح
●منصات تموّلها دول أو مجموعات مصالح
●محتوى يصنعه خبراء لا يظهرون على الشاشات
هذه المنظومات لا تقدم معلومة… بل تقدم اتجاهًا.
ولا تصنع معرفة… بل تصنع قناعة.
> السؤال ليس: “ماذا يُقال؟”
> بل: “لماذا يُقال الآن؟ ولمن؟ وعلى حساب ماذا؟”
رابعًا: السودان بين السرديتين… دولة تبحث عن صوتها
في واقع معقّد كواقع السودان – بلد في قلب الإقليم، غني بالموارد، متنازع عليه جيوسياسيًا – تتحول السردية إلى ساحة صراع كبرى.
الحرب تُروى بأربعين طريقة
التحالفات تُقرأ بمناظير متناقضة
القوى الخارجية تُصوّر حسب موقع الراوي
المجتمع الدولي يكتب رواية، والإقليم يكتب رواية، والدولة تكتب رواية… والشعب تائه بينها
وهنا يُطرح السؤال الأخطر:
> من يحتكر سردية الدولة؟
هل هم:
●السياسيون؟
●العسكريون؟
●الإعلام؟
●المراكز البحثية؟
●الشارع؟
●الدول المؤثرة؟
الجواب المعقّد:
> لا أحد يملكها منفردًا… لكن الجميع يحاول السيطرة عليها.
خامسًا: ماذا يريد من ينقلها؟ دوافع صناعة الحكاية
راوي السردية لا يعمل في الفراغ… بل يحمل هدفًا:
●من يريد تثبيت الشرعية يكتب رواية بطل–ضحية
●من يريد إسقاط النظام يكتب رواية فساد–انهيار
●من يريد التدخل يكتب رواية مسؤولية دولية
●من يريد مكسبًا اقتصاديًا يكتب رواية موارد–فرص
●من يريد تقسيم البلد يكتب رواية صراع هويات
●ومن يريد إحياء السودان يكتب
رواية مشروع وطني جامع
> وهنا تعيد رؤية “الجسر والمورد”
تعريف السردية السودانية بوصفها:
●جسرًا يصل الداخل بالخارج
●موردًا للمعرفة لا للتوجيه
●أداة لإعادة تموضع الدولة في النظام الدولي
●منصة لخارطة طريق تُبنى على التحليل لا على الضجيج
سادسًا: رؤية الجسر والمورد… استعادة السردية الوطنية
تطرح الرؤية منهجًا جديدًا يقوم على:
١) تحليل السرديات المتناقضة بدل تبنّي واحدة منها
أن نفهم اتجاهاتها ودوافعها ومموليها، لا أن نستوردها دون تمحيص.
٢) بناء سردية دولة وليس سردية جماعة
سردية تصنعها المؤسسات، لا الخطابات العابرة.
٣) تحويل المصادر المفتوحة إلى أدوات دعم قرار
لا مجرد أخبار وصور.
٤) بناء جهاز وطني للرصد والتحليل وربط المعلومات يستطيع تحويل التشويش إلى معرفة، والمعرفة إلى سياسات.
٥) إعادة تعريف “الحقيقة السودانية”
ليس كحقيقة جامدة، بل كحقل ديناميكي يتغذى على الواقع لا على الرغبات.
سابعًا: إلى ماذا نريد أن نصل؟
نريد سردية:
●تحمي الدولة لا الأشخاص
●توحّد الشعب لا القبائل
●تكشف الحقائق لا تُخفيها
●تدير الوعي لا تُشوِّهه
●تبني المستقبل ولا تعلق في الماضي
●سردية تجعل السودان فاعلًا لا مفعولًا به…
●وتجعله مُصدّرًا للمعرفة لا مُستوردًا لها…
●وتمنحه موقعًا تفاوضيًا متقدمًا في كل طاولة إقليمية أو دولية.
#أصل_القضية… من يكتب سردية السودان؟
لن تُكتب سردية الدولة السودانية من جديد بأقلام الخارج، ولا بخطاب اللحظة، ولا بضجيج المنصات.
ستُكتب حين تتوافق ثلاثة عناصر:
●دولة تعرف ماذا تريد
●مجتمع يعرف من هو
●مشروع وطني يربط الداخل بالعالم
> وحينها فقط… يصبح السودان قادرًا على أن يروي قصته، لا أن تُروى عنه.
هذه هي رؤية الجسر والمورد ،
ليست سردية تُضاف إلى السرديات…
بل مشروع يعيد ترتيب الوعي، ويمنح الدولة صوتها، ويحوّل المعلومة من أداة صراع إلى أداة بناء.